يشرح عالم النفس العصبي Eriz Badiola في هذا المقال ما هي الأنوسوغنوزيا، بماذا قد ترتبط وما هي تبعاتها في الحياة اليومية.
الأنوسوغنوزيا عادة ما تكون جانبًا ثانويًا عند الحديث عن علم النفس العصبي. لذلك، يهدف هذا المقال إلى توضيح ما هي، بماذا قد ترتبط وما هي تداعياتها في الحياة اليومية والعيادة.
ما هي الأنوسوغنوزيا؟
الأنوسوغنوزيا، كلمة جديدة مشتقة من الكلمات اليونانية a (بدون)، nosos (مرض) و gnosis (معرفة)، حرفياً يمكن أن تعني «فقدان إدراك المرض». أي أن وجهة نظر شخص ما حول محددات معينة (معرفية، سلوكية، عاطفية أو وظيفية) تختلف عن وجهة نظر الآخرين أو عن نتائج الاختبارات الموضوعية.
قد يحدث هذا كنتيجة لإصابات دماغية ناجمة عن ضرر دماغي مكتسب أو أمراض تنكسية عصبية (Mograbi y Morris, 2018).
قد تمتد هذه الصعوبة في إدراك الحدود إلى عدة جوانب: من الاعتقاد بأنه يستطيع الرؤية عندما يعاني من عمى قشري نتيجة أضرار في الفص القذالي (متلازمة أنطون-بابينسكي)، إلى تجاهل أنه ينسى قائمة التسوق، مرورًا بأداء سلوكيات لم يكن يقوم بها سابقًا ومرة أخرى عدم الإدراك بذلك.
وبالمثل، ينبغي الإشارة إلى أن الأنوسوغنوزيا قد تكون جزئية، فقد يكون المريض واعياً لاضطراب معين لكنه يغفل الآخرين، أو قد يقلل حتى من أهمية المشكلة.
تاريخ الأنوسوغنوزيا
يعود اكتشاف هذه الحالة الغريبة إلى عام 1914، عندما كان العالم العصبي الفرنسي-البولندي Joseph Babinski (قد يكون اسمه مألوفًا أيضًا بسبب علامة بابينسكي، انعكاس أخمصي) يعمل مع مرضى أصيبوا بسكتة دماغية في نصف الكرة الأيمن وفي أعقاب ذلك كانوا يعانون من شلل نصفي أيسر. في ترجمة النص الأصلي إلى الإنجليزية لـ Langer و Levine (2014) يذكر أنه عندما طُلب من إحدى المريضات رفع كلتا يديها، كانت ترفع اليد اليمنى دون مشكلة وعندما طُلب منها رفع اليسرى إما لم تكن ترد أو كانت تقول إنها رفعتها. وبوضوح لم تكن قادرة على رفعها، لكنها كانت تعتقد أنها قد فعلت.
الأنوسوديافوريا
في مقالة 1914، صاغ جوزيف مصطلح الأنوسوغنوزيا، بل وأضاف كلمة أخرى إلى هذا السياق: الأنوسوديافوريا (اللا مبالاة). استخدم هذه الكلمة للإشارة إلى حالة المرضى الذين كان الشلل النصفي قائمًا لديهم، لكن أهمية الشللیة أصبحت في المرتبة الثانية. بعبارة أخرى: رغم وعيهم بشللهم النصفي، لم يهتموا على الإطلاق ولم يذكروا أي انزعاج بخصوصه (Langer y Levine, 2014).
لا تزال هناك جوانب كثيرة معلقة ومن هنا نشأ نقاش استمر خلال القرن الماضي: هل الأنوسوغنوزيا موجودة فعلاً أم أن المريض يتظاهر؟ هل ينكرها؟
النقاش بين الأنوسوغنوزيا وإنكار العجز
كان بطلنا يؤمن بوجود الأنوسوغنوزيا، رغم أنه لم يكن يعرف كيفية إثبات ذلك. إذ لم يبدو له معقولًا أن يتظاهر المريض لِأشهر طويلة بأن ذراعه تعمل بشكل طبيعي.
من ناحية أخرى، يقترح بعض المؤلفين أن إنكار العجز يفسَّر من خلال النموذج النفسي التحليلي، رابطين بين انعدام الوعي والمقاومات أو آليات الدفاع (Ramachandran, 1995; Sims, 2014). ومع ذلك، تطرح وجهات النظر العصبية المعاصرة أن استخدام آليات الدفاع ينبغي أن يُؤطر في حالات يكون فيها الأنوسوغنوزيا لا يعتمد على اضطرابات معرفية عصبية (Mograbi y Morris, 2018).
حالياً، نعلم أن الأنوسوغنوزيا حقيقة إلى حد كبير عصبية-نفسية وأن إصابات دماغية محددة قد تؤدي إلى هذه الحالة. علاوة على ذلك، توجد مقابلات عصبية-تشريحية تقربنا من فهمها.
الأسس العصبية التشريحية للأنوسوغنوزيا والانتشار
نبّه بابينسكي إلى أن الأنوسوغنوزيا قد تُعزى إلى إصابات في نصف الكرة الأيمن وأن الاضطرابات الحسية قد تؤثر في وجودها (في الواقع، لم يكن المرضى يتفاعلون مع مؤثرات خارجية في تلك الأطراف).
اليوم سيكون خطأً تحديد أن إصابة محددة في مكان دقيق يمكن أن تؤدي بالضرورة إلى اضطرابات نفسية عصبية محددة. ومع ذلك، يمكننا القول إن إصابات في هياكل معينة قد تعزز حدوث هذه الاضطرابات أو أن إصابات في مناطق متنوعة قد ترتبط بها بشكل محتمل.
كما ذكرت سابقًا، فإن مسببات الأنوسوغنوزيا متنوعة، حيث توجد نسبة حدوث بين 10 و 18% لدى المرضى الذين أصيبوا بـ حوادث سكتية دماغية ويعانون من شلل نصفي، بينما يعتبر أن ما يصل إلى 81% من الأشخاص المشخّصين بـألزهايمر يعانون من نوع ما من الأنوسوغنوزيا وأن 60% من الذين يعانون من ضعف إدراكي خفيف سيختبرونه أيضًا (Acharya y Sánchez-Manso, 2018).
في حالة الأنوسوغنوزيا المتعلقة بالشلل النصفي، على الرغم من أنها أكثر شيوعًا في الإصابات الجانبية اليمنى أو الثنائية، فإن تكرار ظهور الأنوسوغنوزيا متشابه لدى الأشخاص ذوي الإصابات (تحت القشرية و/أو القشرية) في المناطق الزمانية، الجداريّة أو الجبهية. ومع ذلك، فإن احتمال وجود أنوسوغنوزيا أعلى لدى الأشخاص الذين يعانون من إصابات على مستوى الجبهة والجزء الجداري معاً، مقارنةً بالإصابات في مناطق دماغية أخرى (Pia, Neppi-Modona, Ricci y Berti, 2004).
الأنوسوغنوزيا في الضعف الإدراكي الخفيف
في مراجعة منهجية حديثة (Mondragón, Maurits y De Deyn, 2019) يُذكر أنه لدى المرضى ذوي الضعف الإدراكي الخفيف عادةً ما توجد صلة بين الأنوسوغنوزيا وانخفاض التروية، بالإضافة إلى النشاط في الفص الجبهي وفي الهياكل على الخط المتوسط.
الأنوسوغنوزيا في مرض ألزهايمر
وبالمثل، فيما يتعلق بالأنوسوغنوزيا في مرض ألزهايمر، تُظهر الدراسات التي راجعناها انخفاضًا في التروية والتنشيط والأيض في المناطق على الخط المتوسط القشري، ويتم الكشف عن نفس الظاهرة في الهياكل الجداريّـة–الزمنية في مراحل متقدمة من المرض.
التداعيات في التقييم وإعادة التأهيل العصبي النفسي
أولاً، في التقييم العصبي النفسي قد يحدث أنه نظرًا للأنوسوغنوزيا، يشكك المريض في الإجراءات المتبعة. «لماذا تطرح عليّ كل هذه الأسئلة؟» قالت لي مريضة جاءت لإجراء تقييم لبدء إعادة تأهيل عصبي نفسي بعد ACV. قد تُعيق عدم التعاون أثناء التقييم سيره والمواجهة ليست دائمًا حلًا (على الرغم من وضوح الأمر، سأشرح لاحقًا السبب). لذلك، وبما أن ظهور الأنوسوغنوزيا متنوع جدًا، عند إجراء التقييم العصبي النفسي ينبغي تكييف الاختبارات المراد تطبيقها مع الوضع الفردي والفريد لكل مريض. وبالتالي، يظل تحت تصرف المختص قرار كيفية معالجة الوضع بالمهارات التي يكسبها مع الخبرة.
ويمكن أن تحدث حالة أخرى خلال جلسات التأهيل حيث أن المريض الذي يعاني من مشاكل في الذاكرة (على سبيل المثال، الأشخاص المصابون بألزهايمر) قد يتجاهل وجود عجز في الذاكرة، وقد تزداد احتمالية الأنوسوغنوزيا كلما تقدم المرض أكثر (Hanseew et al., 2019). ما يحدث مع الأنوسوغنوزيا المرتبطة بمشاكل الذاكرة والأشخاص الذين يعانون منها (لا سيما ذاكرة الحوادث) هو أنه مهما واجهت المريض بوجود مثل هذه الصعوبات، فلن يكون ذلك مجدياً، لأنهم سيشعرون بسوء وربما لا يتذكرون ما حدث في الجلسة التالية. في هذا السياق، أوصي بمشاهدة «متى وكيف معالجة الأنوسوغنوزيا؟»، فيديو يفرّق بين النهج للأشخاص المصابين بألزهايمر ولأولئك الذين يعانون من DCA (Ruiz-Sánchez de León, 2020).
لذلك، يجب ألا نغفل إبلاغ وتثقيف الأقارب ومقدمي الرعاية ليأخذوا الأنوسوغنوزيا بعين الاعتبار، لأنها قد تكون مصدرًا للصراعات حيث قد يشعر كل من المريض والقريب بالسوء. في هذا السياق، ركيزتان مهمتان للتعامل مع هذه الحالة هما: الفهم والتعاطف. سواء من جانب الأقارب أو من جانب الأخصائي العصبي النفسي الإكلينيكي.
باختصار، الأنوسوغنوزيا رفيق مخلص للضرر الدماغي المكتسب والأمراض التنكسية العصبية، ويجب أن نأخذها بعين الاعتبار في كل من التقييم وإعادة التأهيل العصبي النفسي. يجب أن يكون النهج مكيّفًا مع المريض وأن يُطرح من منظور متعدد التخصصات. كما ينبغي إشراك الأقارب أنفسهم وجعلهم شركاء في الطريق نحو تحسين جودة حياة الأشخاص الذين نرغب في مساعدتهم.
المراجع
- Acharya, A. B., و Sánchez-Manso, J. C. (2018). Anosognosia. StatPearls Publishing: Treasure Island (Florida).
- Hanseeuw, B. J., Scott, M. R., Sikkes, S. A., Properzi, M., Gatchel, J. R., Salmon, E., … و Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative. (2020). Evolution of anosognosia in alzheimer’s disease and its relationship to amyloid. Annals of neurology, 87(2), 267-280.
- Langer, K. G., و Levine, D. N. (2014). Babinski, J. (1914). Contribution to the study of the mental disorders in hemiplegia of organic cerebral origin (anosognosia). Traducido por K.G. Langer & D.N. Levine. Traducido del original Contribution à l’Étude des Troubles Mentaux dans l’Hémiplégie Organique Cérébrale (Anosognosie). Cortex; a journal devoted to the study of the nervous system and behavior, 61, 5–8.
- Mondragón, J. D., Maurits, N. M., و De Deyn, P. P. (2019). Functional neural correlates of anosognosia in mild cognitive impairment and alzheimer’s disease: a systematic review. Neuropsychology review, 29(2), 139-165.
- Mograbi, D. C., و Morris, R. G. (2018). Anosognosia. Cortex; a journal devoted to the study of the nervous system and behavior, 103, 385-386.
- Pia, L., Neppi-Modona, M., Ricci, R., & Berti, A. (2004). The anatomy of anosognosia for hemiplegia: a meta-analysis. Cortex, 40(2), 367-377.
- Ruiz-Sánchez de León, J.M. [LOGICORTEX Neuropsicología]. (2020, 2 septiembre). ¿Cuándo y cómo abordar la anosognosia? [Archivo de vídeo]. تم الاسترجاع من https://www.youtube.com/watch?v=uJi7_v_CluM
- Ramachandran, V. S. (1995). Anosognosia in parietal lobe syndrome. Consciousness and cognition, 4(1), 22-51.
- Sims, A. (2014). Anosognosia and the very idea of psychodynamic neuroscience (No. Ph. D.). Deakin University.
مزيد من المراجع الموصى بها
- Orfei, M. D., Caltagirone, C., و Spalletta, G. (2009). The evaluation of anosognosia in stroke patients. Cerebrovascular diseases, 27(3), 280-289.
- Starkstein, S. E. (2014). Anosognosia in Alzheimer’s disease: diagnosis, frequency, mechanism and clinical correlates. Cortex, 61, 64-73.
إذا أعجبك هذا المقال عن الأنوسوغنوزيا، فقد تهمك أيضاً هذه المشاركات الأخرى:
“تمت ترجمة هذا المقال. رابط المقال الأصلي باللغة الإسبانية:”
Anosognosia: qué es, historia y realidad neuropsicológica



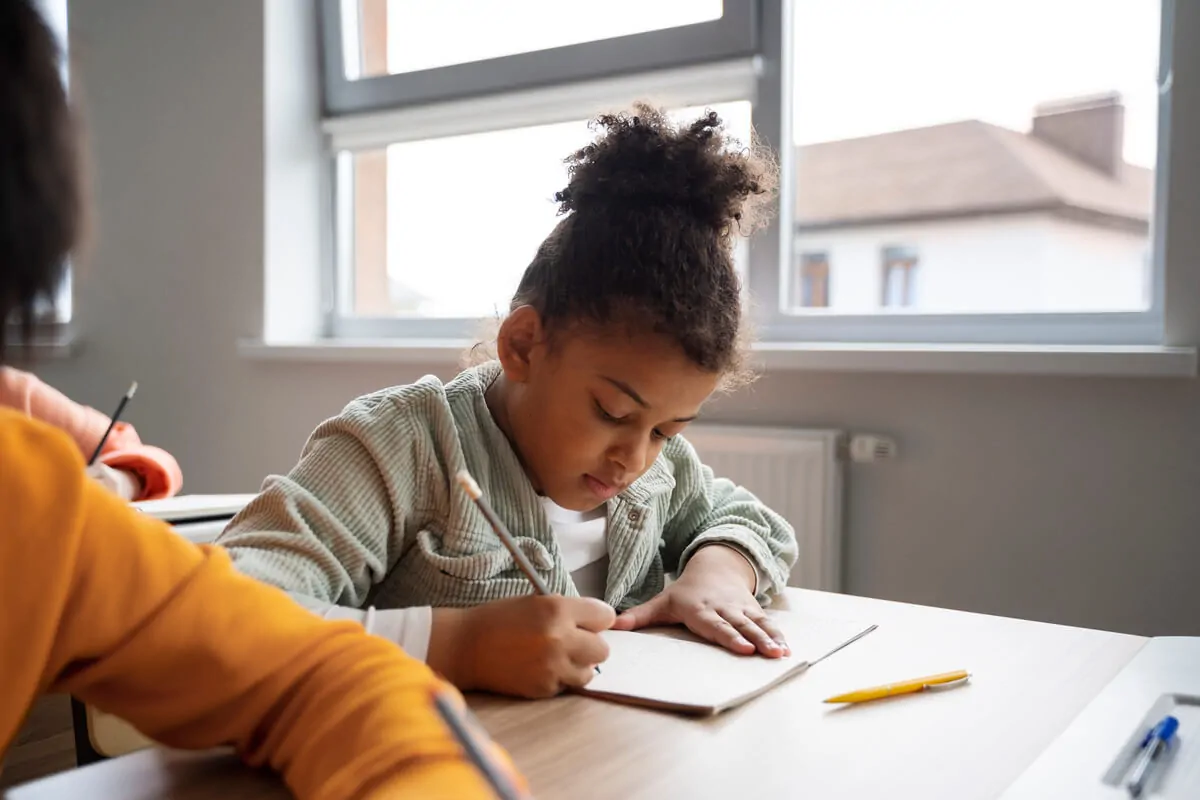



 التربية العصبية: علم الأعصاب التطبيقي في التعلم المدرسي
التربية العصبية: علم الأعصاب التطبيقي في التعلم المدرسي
اترك تعليقاً