تشرح الأخصائية النفسية Kira Guerra Franco في هذا المقال مفهوم الإدمان، مع التركيز خصوصاً على إدمان المواد وعلاقته بدائرة مكافأة الدماغ.
مفهوم الإدمان
الإشارة إلى الإدمان هي ظاهرة معقدة لا يمكن اختزالها حصريًا إلى خلل دماغي. السير على هذا الافتراض يعني الوقوع في أحد المناهج الاختزالية الأكثر شيوعًا داخل التصور البيولوجي-الدماغي للاضطرابات (Elío-Calvo, 2023).
الإدمان كمرض
ترجع الدراسات التي تعتبر الإدمان مرضًا إلى القرن التاسع عشر، واستمرّ هذا الطرح في الازدياد خلال القرن العشرين، لا سيما مع الأبحاث المتعلقة بتعاطي المواد الأفيونية (Becoña, 2016). في هذا الإطار، غالبًا ما كانت الدراسات الممولة من قبل الحكومات أو من جهات ذات مصالح تبحث عن تفسير بيولوجي للإدمان لتصنيفه كاضطراب طبي بدل اعتباره مشكلة اجتماعية أو أخلاقية.
لقد كان لهذا النهج البيولوجي، وما زال، تأثير ملحوظ على كيفية تصور المسؤولية الفردية تجاه السلوك الإدماني (Becoña, 2016). بالتركيز على الجوانب النّووية والكيميائية العصبية للدماغ، يميل هذا المنظور إلى التقليل من قدرة الفرد على اتخاذ القرار، ما يؤدي إلى نوع من “إعفاء من المسؤولية”.
في هذا الإطار، يُطرح أن فقدان السيطرة على تعاطي المواد قد يقع خارج نطاق الإرادة الواعية. ونتيجة لذلك، تتعزز الفكرة القائلة بأن الشخص المدمن، المصنَّف كـ مريض نفسي, يفتقر بالأساس إلى ضبط الذات (Becoña, 2016; Vrecko, 2010).
في أقصى أشكاله، يُهمّش هذا المنظور مسؤولية الفرد فيما يتعلق بالأذى اللاحق بالآخرين، مفضيًا إلى جدالات أخلاقية وقانونية كانت ولا تزال محل نقاش (Gómez, 1995).
لقد تعرض هذا النموذج لانتقادات من قِبَل العديد من الخبراء الذين يرون أن الإدمان لا يمكن تفسيره حصريًا عبر البيولوجيا، إذ إنه ظاهرة تشمل عوامل اجتماعية وثقافية ونفسية وشخصية (Becoña, 2016, 2018).
كما أن تصنيف الإدمان كـ مرض عقلي يضعنا ضمن بنية اجتماعية تميل إلى تصنيف وتجميع الخصائص البشرية في فئات جامدة أو “صناديق”، كل منها مرتبطة بالوصم وسرديات محددة. هذه التصنيفات، التي غالبًا ما تكون ثنائية مثل صحة-مرض أو طبيعي-غير طبيعي، تبسّط التنوع الكامن في التجارب البشرية وتتجاهل أن هذه المفاهيم في الواقع جزء من استمرار ديناميكي.
الصحة والمرض ليسا قطبين متقابلين وثابتين، بل حالتان يمكن أن تتغيرا تدريجيًا تبعًا لعوامل حيوية ونفسية واجتماعية متعددة (Godoy, 1999).
لقد كان مفهوم الإدمان محل نقاش تاريخيًا، وعلى الرغم من أن النموذج البيوميدي قد اكتسب أرضًا في تفسير هذه الظاهرة، يبقى من المهم الاعتراف بالتعقيد الكامن في نشأتها وتطورها (Becoña, 2016).
السلوك التكيفي المدفوع
الإنسان بطبيعته يمتلك سلوكًا تكيفيًا. هذا يعني أنه من خلال الدافع يسعى لتلبية احتياجات مختلفة في درجات ترتيب هرمي، وهو ما يمكن توضيحه من خلال هرم الاحتياجات لماسلو.
وفقًا لما طرحه ماسلو (1943)، يجب تلبية الاحتياجات الأساسية مثل البقاء أولًا قبل أن يسعى الفرد لتحقيق احتياجات أعلى مثل تحقيق الذات. هذه هرمية الاحتياجات يمكن أن تؤثر مباشرة في السلوكيات الادمانية، حيث تتحول المواد أو الأنشطة إلى أدوات لتلبية الاحتياجات الفسيولوجية أو العاطفية الفورية، متجاهلة احتياجات أخرى على المدى الطويل.
السلوك التكيفي المدفوع يتضمن التوجيه نحو هدف وتنشيط الكائن الحي عبر محفزات بيئية أو داخلية، وهو ما وصفه ميرندا بإسهاب (2006). ومن هذا المنظور، يقترح Kalivas و Volkow (2005) أن البحث عن الأساس العصبي الحيوي للسلوك المدفوع يركز على تحديد الركائز الدماغية التي تُعطِي أهمية للمحفزات، مما يسهل استجابة سلوكية محددة تجاهها ويثير استجابات تكيفية أو اندفاعية.
فيما يتعلق بـالمناطق الدماغية المشاركة في تنشيط السلوك المدفوع، يبرز ميرندا (2006) ثلاث مناطق رئيسية:
- اللوزة الدماغية،
- الـ نواة الإكومبنس
- وقشرة الفص الجبهي الأمامية.
تلعب هذه المناطق دورًا حاسمًا في معالجة المكافآت واتخاذ القرارات السلوكية.
دائرة المكافأة
يُعد نظام مكافأة الدماغ مجموعة من البُنى الدماغية التي تنشط استجابة للمحفزات، مطلقة ناقلات عصبية تولد إحساسات بالمتعة والدافع. يؤدي هذا النظام دورًا أساسيًا في تنظيم السلوكيات التكيفية وتشكيل العادات، إذ يسهل التعلم والحفاظ على سلوكيات مثل التغذية أو التكاثر (Méndez-Díaz et al., 2017).
يرتبط هذا النظام بتعاطي المواد من خلال قدرة الكائن على التعلم وتعزيز السلوكيات المرتبطة بالتعاطي، وتخزين المحفزات في الذاكرة التي قد تعمل لاحقًا كمثيرات لإعادة السلوك (Hernández, Serrano, & Jacinto, 2018).
تشمل الهياكل الرئيسية المشاركة في نظام المكافأة (Hernández, Serrano, & Jacinto, 2018):
1. الجهاز الحوفي
المعروف بـ”الدماغ العاطفي”، يشارك في تنظيم العواطف والعمليات التحفيزية والتعلّم. يشمل بنى مثل اللوزة الدماغية والحُصين، اللتين لهما أهمية كبيرة في تشكيل الذكريات والاستجابة العاطفية.
2. المنطقة السقيفية البطنية (ATV)
تقع في الدماغ الأوسط، وهي مصدر رئيسي للخلايا العصبية الدوبامينية التي تُرسل محاورها إلى مناطق دماغية مختلفة، بما في ذلك نواة الإكومبنس وقشرة الفص الجبهي الأمامية. تلعب الدوبامين المحررة من المنطقة السقيفية البطنية (ATV) دورًا في الإحساس بالمتعة والدافع.
3. النواة الإكومبنس (NAc)
جزء من العقد القاعدية، تعمل كواجهة بين الدافع والفعل الحركي. علاوة على ذلك، تتولّى في الغالب استقبال الإشارات الواردة من المنطقة السقيفية البطنية (ATV) وتلعب دورًا أساسيًا في تكوين العادات والاستجابة للمحفزات المعززة، كونها بنية مركزية في تطوير الإدمان.
تنقسم هذه البنية الأخيرة، النواة الإكومبنس (NAc)، إلى منطقتين: الغلاف (shell) والنواة المركزية (core):
- منطقة الغلاف (shell) تستقبل إشارات دوبامينية قادمة من المنطقة السقيفية البطنية (ATV)، مما ينظم الأهمية التحفيزية المنسوبة إلى المحفزات ويسهل تكوين الروابط بين المحفزات البيئية والتجارب المحفزة.
- من ناحية أخرى، تربط المنطقة المركزية (core) اتصالات مع الحزام الأمامي والقشرة المدارية الجبهية، وهما منطقتان تشاركان في تقييم المكافآت واتخاذ القرارات وتعديل السلوك. يتم هذا عبر إسقاطات غلوتاماتية، اللازمة للتعلّم والتكيّف مع مواقف جديدة (Kelley, 2004).
المنهج والخلاصة
للخلاصة، رغم أهمية الاعتراف بـالبُعد البيولوجي في الإدمان، لا ينبغي اعتباره الدعامة التفسيرية الوحيدة أو الجوهر الحصري الذي تُبنى عليه هذه الظواهر.
وبنفس المنطق، يجب أن يتجاوز التعامل مع الإدمان وجهات النظر الاختزالية التي تميل إلى تصنيف الأشخاص حصريًا تحت تسميات تشخيصية. كما يؤكد García Patiño (2022)، “الشخص ليس إدمانه”. هذا المنظور يطالب بتبني منظور يعتبر الفرد فاعلًا وليس موضوعًا سلبيًا للتداوُر. يجب أن تُعطي العلاقات العلاجية الأولوية للفهم والاحترام والبناء المشترك للحلول، مغادرةً النماذج الرأسية والمَرضية التي تكرّس الوصم ونقص القدرة على الفعل.
كذلك، من الضروري الاعتراف بأن النموذج الطبي، الذي يُستخدم كثيرًا في هذا المجال، قد يُستَغَل لخدمة مصالح اقتصادية، مثل مصالح شركات الأدوية. فقد أبرز Cosgrove و Krimsky (2012) وجود تعارضات مصالح في تطوير DSM-5، مسلطين الضوء على كيفية تأثير تسليع التشخيصات على تصور الاضطرابات والأمراض، خصوصًا في حقل مثل الطب النفسي الذي يعتمد على أحكام ذاتية ويفتقر لمؤشرات بيولوجية واضحة (Becoña, 2016).
المراجع
- Becoña, E. (2016). الإدمان “ليس” مرضًا دماغيًا. Papeles del Psicólogo / Psychologist Papers, 37(2), 118-125. https://www.redalyc.org/pdf/778/77846055004.pdf
- Becoña, E. (2018). الإدمانات السلوكية: فصل الحَبوب عن القش. INFONOVA, Revista profesional y académica sobre adicciones, 34, 11-21. https://www.researchgate.net/publication/325989445
- Cosgrove, L., & Krimsky, S. (2012). مقارنة الروابط المالية لأعضاء لجان DSM-IV و DSM-5 مع الصناعة: مشكلة خبيثة مستمرة. PLoS medicine, 9(3), e1001190. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001190
- Elío-Calvo, D. (2023). النماذج الطبية الحيوية والنماذج البيولوجية-النفسية-الاجتماعية في الطب [نماذج طبية حيوية وبيولوجية-نفسية-اجتماعية في الطب]. Revista Médica La Paz, 29(2). http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-89582023000200112
- García Patiño, A. (2022). تجاوز الإدمان. الشخص ليس إدمانه. Revista Española de Drogodependencias, 47(1), 11-21. https://doi.org/10.54108/10001
- Godoy, J. (1999). علم نفس الصحة: تحديد المفهوم. في M. A. Simón (محرر)، دليل علم نفس الصحة: أنماط الحياة وتعزيز الصحة. مواد تعليمية: الأسس، المنهجية والتطبيقات (ص. 39–75). Biblioteca Nueva.
- Gómez, A. P. (1995). الإدمان والمرض: الأسطورة والواقع. Revista Colombiana de Psicología, (4), 67–71.
- Hernández, K. C. R., Serrano, L. M. R., & Jacinto, U. L. (2018). البيولوجيا العصبية لنظام المكافأة في السلوكيات الإدمانية: تعاطي الكحول. Revista electrónica de psicología Iztacala, 20(4). https://www.revistas.unam.mx/index.php/repi/article/view/62805
- Kalivas, P. W., & Volkow, N. (2005). الأساس العصبي للإدمان: مرض في الدافع والاختيار. American Journal of Psychiatry, 162(8), 1403–1413. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.162.8.1403
- Kelley, A. E. (2004). السيطرة المِفْتَحِيَّة للخطوة البطينية على الدافع الشهواني: الدور في السلوك الغذائي والتعلم المرتبط بالمكافأة. Neuroscience and Biobehavioral Review, 27(8), 765–776. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2003.11.015
- Kuhar, M., Droby, L. C., Evans, J. A. F., & Caselli, K. G. (2016). الدماغ المدمن: لماذا نسيء استخدام المخدرات والكحول والنيكوتين والعديد من الأشياء الأخرى. Ediciones UC.
- Maslow, A. H. (1943). نظرية الدافع البشري. Psychological Review, 50(4), 370–396. https://doi.org/10.1037/h0054346
- Miranda, A. V. (2006). البيولوجيا العصبية للإدمانات: ما وراء دائرة المكافأة. Revista de Psiquiatría y Salud Mental Hermilio Valdizán, 7(2), 73-80.
- Méndez-Díaz, M., Romero Torres, B. M., Cortés Morelos, J., Ruíz-Contreras, A. E., & Prospéro García, O. (2017). البيولوجيا العصبية للإدمانات. Revista de la Facultad de Medicina (México), 60(1), 29-38. https://doi.org/10.22201/fm.24484865e.2017.60.1.03
- Vrecko, S. (2010). ولادة مرض دماغي: العلم، الدولة ونيو-سياسات الإدمان. History of the Human Sciences, 23(4), 52–67. https://doi.org/10.1177/0952695110371598
أسئلة متكررة حول الإدمان والدماغ
1. ما هو الإدمان من منظور علم النفس العصبي؟
الإدمان هو اضطراب دماغي مزمن يتسم برغبة إلحاحية في تناول نوع معين من المواد أو أداء سلوك معين على الرغم من العواقب السلبية الناجمة عنه. حالة الإدمان تُعدّل الدوائر الدماغية، لا سيما نظام المكافأة، مسببة تغيّرات تؤثر في السلوك وضبط الدوافع والوظائف التنفيذية.
2. لماذا يُعتبر الإدمان مرضًا؟
تاريخيًا، وخصوصًا منذ القرن التاسع عشر ومع الأبحاث حول المواد الأفيونية، تم تصور الإدمان كمرض لتصنيفه كاضطراب طبي، وهو ما يميل إلى التقليل من المسؤولية الفردية وقدرة المصاب على اتخاذ القرار.
3. ما هي دائرة مكافأة الدماغ وما أهميتها في الإدمان؟
دائرة المكافأة هي مجموعة من البنى الدماغية —بما في ذلك الجهاز الحوفي، المنطقة السقيفية البطنية والنواة الإكومبنس— التي تنشط استجابة للمحفزات الممتعة والمحركة. تعزّز هذه الدائرة تعاطي المواد من خلال ربطه بمشاعر المتعة والدافع، مما يسهل تكوين عادات إدمانية.
4. كيف يرتبط السلوك التكيفي المدفوع بالإدمان؟
السلوك التكيفي المدفوع يعني أن الأفراد يسعون لتلبية الاحتياجات الأساسية والأعلى ترتيبًا، كما يوضحه هرم ماسلو. في سياق الإدمان، تُستخدم المواد أو السلوكيات الإدمانية لتلبية احتياجات فورية، متجاهلة الأهداف الطويلة الأمد.
5. من هم الأكثر عرضة لتطوير الإدمان؟
هناك زيادة في القابلية عند بداية التعاطي في مرحلة المراهقة، أو وجود تاريخ من الصدمات أو الإجهاد، واستعداد وراثي، ووجود أمراض نفسية مصاحبة (قلق، اكتئاب، اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط) وتوفر كبير للمواد. يؤثر السياق الاجتماعي والدعم العائلي على الخطر، مما يؤثر في الانتقال من الاستخدام إلى التعاطي الإشكالي وفي احتمال الانتكاسات.
6. ما الذي تتضمنه التقييمات النفسية العصبية في حالات الإدمان؟
يجمع التقييم بين المقابلة السريرية واختبارات معيارية للانتباه والذاكرة والوظائف التنفيذية وضبط المثبطات، لتقدير العجز وتخصيص الخطة العلاجية. تتيح أدوات مثل Stroop، Trail Making Test، WCST واختبار الأرقام (WAIS) تحديد خط الأساس، وضع الأهداف ومراقبة التغيّر أثناء العلاج.
7. ما العلاجات التي تمتلك أفضل الأدلة للتعامل مع الإدمان؟
تدعم الأدلة نهجًا متعدد الوسائط يدمج التثقيف النفسي، العلاج المعرفي-السلوكي، المقابلة التحفيزية، إدارة الحوافز، منع الانتكاسات والدعم الطبي النفسي عند الاقتضاء. يُحسن الجمع مع عادات صحية والدعم الاجتماعي الالتزام العلاجي، ويقلل خطر الانتكاس، ويحسن النتائج الوظيفية.
8. ماذا تقدم إعادة التأهيل المعرفي في علاج الأفعال؟
تعمل إعادة التأهيل المعرفي على تدريب الذاكرة والانتباه والوظائف التنفيذية لتحسين ضبط الذات واتخاذ القرار من خلال برامج مخصصة مع تغذية راجعة ومتابعة مستمرة. يُسهم هذا النهج في نقل التحسن إلى الحياة اليومية ويتيح تعديل التدخل وفق التقدم، مع تعزيز التعافي الوظيفي والاستقلالية.
إذا أعجبتك هذه التدوينة حول مفهوم الإدمان ودائرة مكافأة الدماغ، فمن المؤكد أنك ستُثير اهتمامك هذه المقالات من NeuronUP:
“تمت ترجمة هذا المقال. رابط المقال الأصلي باللغة الإسبانية:”
El concepto de adicción y el sistema de recompensa cerebral

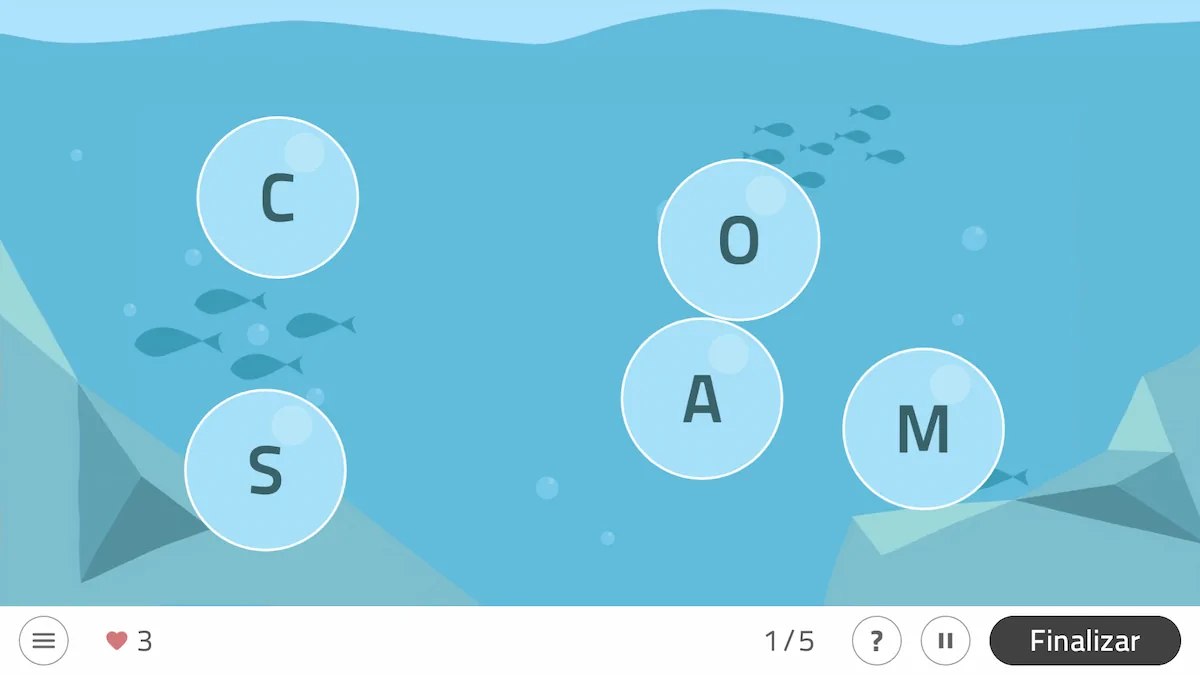

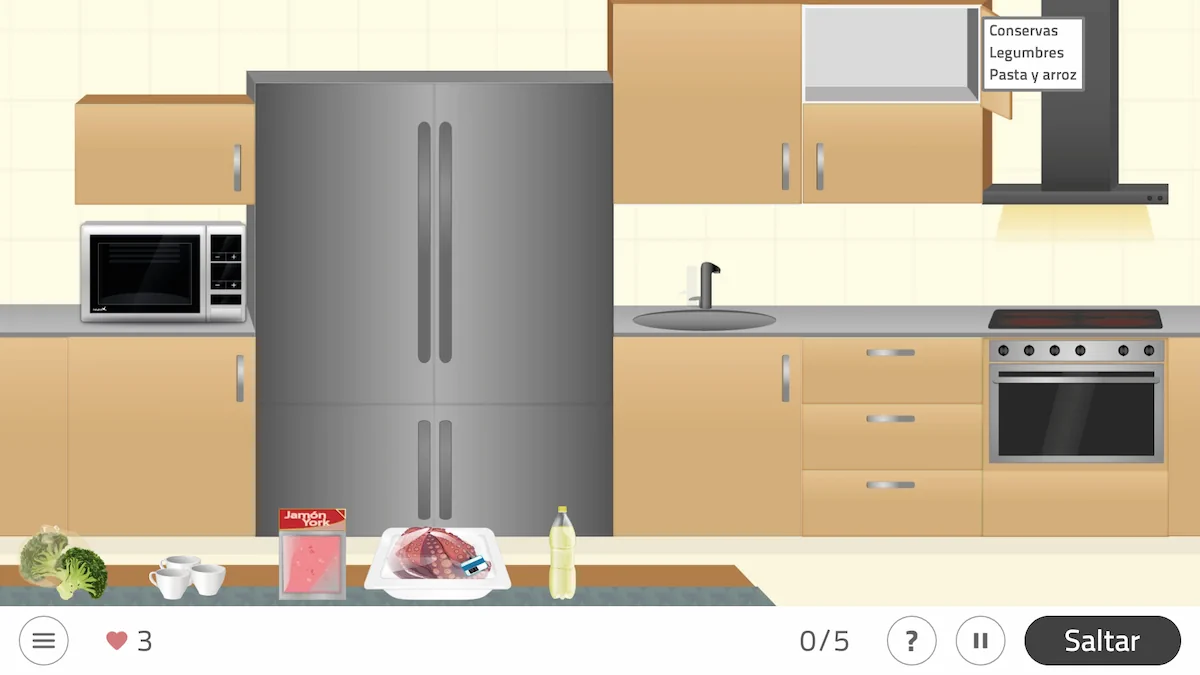


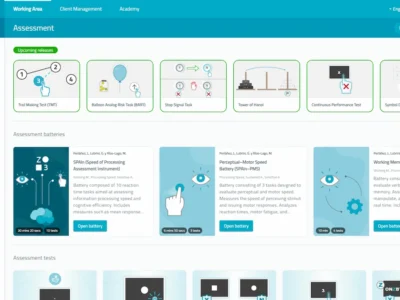
اترك تعليقاً