تعريف نظام الخلايا المرآتية
التشريح العصبي للخلايا المرآتية النظام الحركي/التقليد:
هناك شبكتان عصبيتان رئيسيتان تشكلان نظام الخلايا المرآتية (Cattaneo & Rizzolati, 2008): إحداهما تتكون من مناطق في الفص الجداري والقشرة ما قبل الحركية، وكذلك الجزء القّصّي من الالتفاف الجبهي السفلي؛ وأخرى تتكون من الجزيرة والقشرة الجبهية الوسطى الأمامية.
سنركز الآن على النظام الأول، الذي يشارك في التعلم القائم على الملاحظة والتقليد. التنظيم التشريحي للنظام الأول يستجيب لـتسلسل جسماني خرائطي في القشرة ما قبل الحركية البطنية، حيث تُواجد الأفعال الحركية للساقين في المنطقة الظهرية؛ والسلوكيات الوجهية متوضعة بطنيًا، واليدوية بتوزيع متوسط. تمثّل الأفعال الحركية القريبة (تحريك اليد تجاه نقطة) بشكل ظهري، بينما الفعل البسيط للإمساك ينتج نشاطًا بطنيًا في القشرة ما قبل الحركية. من ناحية أخرى، تُنتج ملاحظة الأفعال الحركية تفعيلًا تمايزياً في القشرة الجداريّة أيضًا.
ملاحظة الأفعال المنقولة (الهادفة إلى كائن/شيء) تُنتج تفعيلًا في الثلم الجداري الداخلي، وكذلك تفعيلًا في سطح الفص الجداري المجاور لتلك المنطقة. ملاحظة الأفعال غير المنقولة –سواء كانت أفعالًا رمزية أم تكرارًا تمثيليًا– تظهر نشاطًا مميزًا في الجزء الخلفي من الالتفاف فوق الحدي، الذي يمتد إلى الالتفاف الزاوي. أخيرًا، ملاحظة الأفعال التي تُنفَّذ باستخدام أدوات تنشط بشكل خاص الجزء الأنسي الأكثر أمامية من الالتفاف فوق الحدي.
نظام الخلايا المرآتية ينتج استحضار الفاعل الحركي المرصود داخل القشرة ما قبل الحركية نفسها. يتناسق هذا النشاط في الوقت ذاته مع الفص الجداري. من الضروري تمييز تسلسل عمليات الملاحظة لتحديد تشريح الأعصاب للنظام الأول المعروض (الجبهوي-الجداري) بشكل صحيح. في هذا النظام، سنتحدث عن سلوكيات مشاهدة تفترض تمهيد بصري-حركي لتنفيذ –أو عدم تنفيذ– فعل.
لذلك، سنستبعد مفهوم التمهيد الحركي-البصري الذي يتضمن توقعات للعواقب أثناء تخطيط الأفعال. نشاط هذا النظام الجبهوي-الجداري –وها هو المهم– يحدث عندما يكون السلوك موجودًا –إمكانيًا– في ريبيرتور الشخص. بمعنى آخر، إنسان يراقب نباحًا لا يُنشط المناطق ما قبل الحركية والجداريّة، لأنه لا يمتلك ذلك السلوك في قشرته.
من ناحية أخرى، نشاط النظام يتناسب مع خبرة المراقب في السلوك الذي يلاحظه. الاتصال الوظيفي للنظام الجبهوي-الجداري للخلايا المرآتية يظهر تسلسلاً أثناء الملاحظة. أصلاً يبدأ هذا التسلسل في الفص القذالي، حيث تُسجل الخصائص الرئيسية للمحفزات المرصودة. تُرسل كل المعلومات إلى مناطق التكامل عبر سلسلة من الخطوات التي تتراوح بين 20 ملِّي ثانية و60 ملِّي ثانية، بالترتيب التالي: أولًا ثلم الصدغي العلوي، ثم إلى الفص الجداري السفلي، بعد ذلك تذهب المعلومات إلى الالتفاف الجبهي السفلي وأخيرًا إلى القشرة الحركية الأولية.
Iacoboni et al. (1999) يقترحون أن المناطق الجبهية التي تُفعل تُعنَى بـحساب الأهداف المراد تحقيقها، بينما النشاط الجداري يتوافق مع تفعيل التمثيلات الحركية للأفعال التي تُرصد. مع ذلك، مجموعة Iacobini تُجري تمييزًا وظيفيًا في النشاط العصبي للنظام، مركزةً على pars opercularis للالتفاف الجبهي الأيسر. بالنسبة لهم، تنشط المنطقة الظهرية من pars عندما يُرصد الفعل وعندما يُقلد؛ لكن لا يحدث نشاط بطني إلا عند التقليد. في الواقع Iacoboni et al. (2005) يحللون وظيفيًا التفعيلات المشارَ إليها سابقًا.
بالنسبة لهم، نظام الخلايا المرآتية أساسي للتعلم عبر التقليد. وسيُكمَل تسلسل التفعيل بالطريقة التالية:
- (i) أولًا يحدث تفعيل في ثلم الصدغي العلوي، حيث توجد التمثيلات –المسار البطني للحركات المرصودة.
- من هناك (ii) يتم الانتقال إلى ترميز أهداف الفعل، عبر النظام الجبهوي-الجداري، حيث تتولى القشرة الجبهية أمام الحركية الظهرية حساب الجوانب المختلفة للفعل، مثل الهدف ذاته أو المعنى، وأرشفة هذه المعلومات، وإرسال معلومات إلى الفص الجداري وتصحيح الحسابات المتعلقة بالمكان.
تُرسل هذه المعلومات الصادرة من نظام الخلايا المرآتية الجبهوي-الجداري، عبر pars opercularis، نحو ثلم الصدغي العلوي مرة أخرى. في هذه النقطة، سيحدث حساب للمطابقة بين العواقب المتوقعة في الفعل التقليدي المخطط، والوصف البصري للفعل المرصود. باختصار، يُشكِّل نظام الخلايا المرآتية الجبهوي-الجداري نظام تعلم قائم على التغذية الراجعة.
في الواقع، ما يُنقَل من المناطق البصرية إلى المناطق الحركية ليس برنامجًا حركيًا تفصيليًا، بل نموذجًا أوليًا للفعل، فعل ذو معنى يُعالَج في pars opercularis للالتفاف الجبهي السفلي؛ والذي يُوجِّه بعد ذلك التخطيط الحركي وفقًا لتمثيل تفصيلي دقيق للفعل المرصود، ممثلًا في ثلم الصدغي العلوي وفي الفص الجداري السفلي. عندما يكون الفعل المرصود جديدًا، قبل فترة التنفيذ، يحدث تفعيل لنظام الخلايا المرآتية الجبهوي-الجداري، بالإضافة إلى تفعيل المنطقة AB 46 والقشرة الجبهية الوسطى الأمامية.
يتحول هذا التفعيل إلى آلية للتحكم التنفيذي، ربما كجزء من آلية المشرف لدى شاليس (Shallice) التي استند إليها بادلي (Baddeley, 2000) في صياغة آلية الذاكرة العاملة. في حالتنا، قد ينطوي هذا النظام على حساب للتخطيط الأعلى-إلى-الأسفل للحركة، حيث تتعامل الذاكرة العاملة مع المحتويات المرصودة وتخطط الحركة اعتمادًا عليها، منتجة نشاطًا جبهويًا-جداريًا يتوافق مع آلية الخلايا المرآتية.
لا ينبغي تصور نظام الخلايا المرآتية كوحدة عصبية منفصلة، بل كـآلية متأصلة وأساسية في معظم المناطق المتعلقة بالحركات الحركية. في الواقع، وكما سنرى لاحقًا، تعطيل هذا النظام لا يسبب عجزًا انتقائيًا في إصابات بؤرية. بل تُلاحظ مشاركة هذا النظام في اضطرابات تطورية للجهاز العصبي، وفي إصابات الفص الجبهي. لننظر في هذه الحالة الأخيرة لاحقًا.
التبعية والتسلسل الهرمي
كما ذُكر، فإن نظام الخلايا المرآتية يتداخل مع أنظمة أخرى، ونظام التحكم ليس استثناءً، إذ يكبح السلوكيات التلقائية للتقليد. تُحدث إصابات الفص الجبهي سلسلة من العجزات المميزة بظهور سلوكيات اندفاعية ناتجة عن محفزات خارجية. السلوك التقليدي ذو صلة خاصة مع نظام الخلايا المرآتية، وقد يكون جزءًا من «متلازمة الاعتماد البيئي». عادةً تظهر الحالة نتيجة لإصابة ثنائية، رغم أنه يمكن أن تنجم أيضًا عن إصابة أحادية، والأقل شيوعًا. ملاحظة سلوك الآخرين يمكن أن يستثير تفعيل المناطق ما قبل الحركية والجداريّة، التابعة لنظام الخلايا المرآتية.
في الأفراد الأصحاء، لا يظهر هذا التفعيل لأن هناك تثبيطًا من قِبل الفص الجبهي. تدهور هذا الأخير يعني تدمير هذه الآليات، محولًا الأفعال المحتملة إلى أفعال واقعية. تشكّل الإيكوبراكسيا التقليد القسري والنقدي للسلوكيات المرصودة، عادةً مع وجود استمراريات. على الرغم من ارتباطها غالبًا باضطراب ناتج عن ضرر في العقد القاعدية، إلا أنها تحدث أيضًا بسبب تدهور جبهي، ما يؤدي إلى فك تثبيط نظام الخلايا المرآتية.
وظائف النظام الجبهوي-الجداري للخلايا المرآتية
التقليد والتعلم
مهمة أساسية للتعلم هي التقليد، الذي يؤدي إلى تطوير بعض المهارات الأساسية للتطور الاجتماعي، خصوصًا في اكتساب التعرف الإيمائي والوضعيات، ويمكنه أن يتيح تطور فهم قصد الآخر.
تنبعث هذه الخلايا عندما يؤدي الشخص سلوكيات مرتبطة بهدف، ولكن بشكل خاص عندما يلاحظ هذه السلوكيات في الآخرين، مميزةً بين المكونات المختلفة للفعل بحسب كون بعضها أو تَعدّها أكثر أو أقل أهمية من منظور القصد؛ حتى في مواجهة أجسام غير حاضرة.
مما سبق نستنتج أن الخلايا المرآتية لا تتعامل فقط مع محتويات مرتبطة بأنماط حركية أو بصرية، بل أيضًا مع محتويات مجردة، سواء فيما يتعلق بنمط الاستقبال الحسي للترابط (صوت ذو معنى) أو فيما يتعلق بعناصر ذات طبيعة غير حاضرة أو مجردة، والتي ترتبط، من حيث التعلم، بالنية، وهي حقيقة تلعب فيها فهم دوافع الآخرين دورًا مهمًا.
المعلومات الحركية المتكاملة تظهر خصائص عملية ذات أهمية:
- معالجة الحركة،
- أجزاء من الجسم،
- متابعة الفعل الموجَّه نحو هدف لشخص خارجي،
- إلخ.
القرب من أنظمة جبهوية-جداريّة تدعم أنواعًا متعددة من التكامل الحسي-حركي يوحي بأن ترميز الفعل المنفَّذ في نظام الخلايا المرآتية مرتبط بشكل ما بصورة من التكامل الحسي. التقليد هو إحدى صور هذا النوع من التكامل. في هذا التكامل، يقوم المراقب بإجراء مقارنات بين المعلومات الموجودة في المناطق الأولية (مدخلات بصرية) والسلوك المرصود، كما تم شرحه أعلاه.
أدبيات سلوكيات التقليد تؤكد أن جانبًا أساسيًا في هذا المجال هو التمييز بين أشكال مختلفة من التقليد أو العدوى، وبين التقليد الحقيقي –أي إضافة شيء جديد إلى ريبيرتور المرء الحركي بعد ملاحظة الآخرين يؤدون ذلك الفعل-. يُلاحظ هذا التمييز على مستوى عصبي، مميزًا التفاعلات بين نظام الخلايا المرآتية وبنى التحضير للتنفيذ الجبهية والجداريّة أثناء التعلم بالتقليد، والتفاعل بين نظام الخلايا المرآتية والنظام الحوفي أثناء العدوى العاطفية. ربما، كما سنناقش لاحقًا، يسمح نظام الخلايا المرآتية في التوحد أيضًا بإجراء هذا التمييز، حيث يكون أحد أنظمة التفاعل أكثر تضررًا من الآخر.
الخلايا المرآتية تملك خصائص فردية:
تُفعّل عند الفعل المقلَّد، ولكن أيضًا عند الفعل الذي يُرصد حتى دون تقليده. تمتلك مستويين من التوافق:
- صارم، حيث تُفعّل الخلايا حصريًا في الأفعال والمشاهدات المتطابقة جوهريًا؛
- وتوافق تقريبي، حيث تُفعّل استجابةً لملاحظة فعل ليس بالضرورة مطابقًا للفعل المنفَّذ، ولكن يحقق نفس الهدف.
تعرَّف حدود التفعيل وفقًا لمنطق الفعل، لا وفقًا للشيء أو مسافة الفعل. من هذه الخصائص نستنتج أنهم يتعاملون مع محتويات مجردة للأفعال المرصودة. لكن ما هو مدى تجريد هذا الترميز؟ مرتفع، كما يُبرهن في تجارب ذات شروط سابقة لـ«التغطية»، حيث تنشط الخلايا بناءً على حالة بداية وجود أو عدم وجود، مميزةً حالات مختلفة.
هناك تمييز حسي للأفعال الصوتية (مدخلات سمعية) في نظام الخلايا المرآتية. هذا يسمح بوضع أساس لفهم الكلام واللغة كرمز يُتعلَّم –على الأقل في المراحل الأولية– عن طريق التقليد الجسدي والإيمائي.
التسلسل الوظيفي الهرمي للنظام الجبهوي-الجداري في المعالجة الحركية
كما ذُكر أعلاه، هناك تسلسل وظيفي هرمي في نظام الخلايا المرآتية عندما يراقب الشخص فعلًا حركيًا بهدف تعلمه. لقد دُرست المستويات الأساسية للمعالجة الحركية بوفرة. ومع ذلك، يستجيب نظام الخلايا المرآتية لتسلسل هرمي حيث أن معالجة الحركات هي عالية المستوى، منتجةً حسابات بين عواقب الفعل والأهداف.
لحساب ذلك المعارف يجب فصل المكونات التي تعرض سياق الفعل: أولًا، الجسم نفسه الذي يشكل الهدف. لم تكن الدراسات الموجودة حاسمة حتى وقت قريب نسبيًا. ومع ذلك، باستخدام تقنيات قمع عصبي، مثل التحفيز المغناطيسي, تم فصل معالجة المدى العالي عن المعالجة الحركية الحرفية. لوحظ أن تحديد الجسم-الهدف يُحسب في الثلم الجداري الداخلي الأمامي (Hamilton & Grafton, 2006). وبالتالي، هناك معالجة تمايزية للأجسام، حتى وإن كان الفعل نفسه (مثل الإمساك). من ناحية أخرى، تنطوي هذه الفصالة أيضًا على تحليل العواقب المتوقعة للفعل، والتي تملك مستوى هرميًا أعلى من السابق.
من المهم جدًا أن نضع في الاعتبار أن معالجة الأهداف تتضمن معالجة الحركات اللازمة لتحقيق ذلك الهدف، لكنها جوانب ذات مستوى معالجة مختلف، حيث إن معالجة برنامج الحركة (لا تخطيطه) هي مستوى معالجة أدنى. أظهر Hamilton & Grafton (2007) أن هناك تأثيرًا جانبياً لنظام الخلايا المرآتية الذي يحسب عواقب الفعل. وجدوا أن عواقب فعل مرصود تُعالج في الالتفاف الجبهي السفلي والفص الجداري السفلي الأيمن، وكذلك في الثلم بعد المركزي الأيسر والثلم الأمامي الجداري الداخلي الأيسر.
بالمجمل اقترحوا نموذجًا هرميًا يتألف كالتالي: من جهة، تحدث معالجة منخفضة المستوى –معرفية– تتضمن معالجة النمط الحركي. معالجة النمط الحركي تحدث في نظام يشمل تحليلًا بصريًا وحركيًا للفعل. يتم الجزء البصري في مناطق قذالية جانبية، بينما معالجة النمط الحركي الحركي تتم في المناطق الجبهية السفلية.
المعالجة عالية المستوى، المحددة بتحليل الأهداف، تتم في نظام يضم منطقتين في نصف الكرة الأيمن: الثلم الجداري والالتفاف الجبهي السفلي –بدرجة أقل-. في هذه معالجة الأهداف، تُعالَج الأجسام-الأهداف أيضًا بطريقة جانبية في القشرة الجداريّة السفلية اليسرى. هل هناك تسلسل هرمي عصبي عندما تُنفَّذ الأفعال المرصودة؟ نعم، والفروق الهرمية تميّز تعقيد الأفعال، أي عندما تكون الأفعال بسيطة، عندما تكون معقدة –مركبة من خطوات مختلفة–، وكذلك عند استجابتها لنية ما. في هذه الحالة، لا تبدو جوانب التمركز الجانبي للنشاط العصبي واضحة جدًا.
هناك أدلة على أن تخطيط الأفعال البسيطة يحدث في القشرة الحركية وما قبل الحركية، وكذلك في القشرة الجداريّة السفلية اليسرى. ومع ذلك، يبدو أن الفص الجداري السفلي الأيمن متورط في السلوكيات المعقدة التي تتطلب عدة خطوات، مثل مهمة أبراج لندن (Newman et al., 2003). تبدو هذه المنطقة مهمة لإرسال تغذية راجعة حول عواقب الفعل الحركي، ومع السيريبيلوم يمكنها حساب تصحيحات الحركة في المكان أو في التخطيط.
اللغة
أثناء مهمة تقليد حركة الأصابع، يُلاحظ ازدياد في نشاط القشرة الجداريّة الخلفية الأمامية وفي الالتفاف الجبهي السفلي، مناطق قريبة من منطقة بروكا، مما يوحي بمشاركة هذه المناطق المرآتية في آلية اكتساب اللغة من النوع الفِيلوجيني (Iacoboni & Dapretto, 2006).
لقد دعمت هذه النظرية مؤشرات عديدة. أولًا تم إظهار تمركز يساري لنظام الخلايا المرآتية. من ناحية أخرى، يسمح تفعيل نظام الخلايا المرآتية في دماغ القرد باسترجاع مناطقها إلى مناطقنا: فالمناطق في القرد تتقاطع مع AB 44 لدى الإنسان، المجاورة لمنطقة بروكا. استنادًا إلى نظرية التعبير الدلالي التي تقترح أن اللغة تُتعلَّم في عملية من أسفل إلى أعلى (bottom-up)، ومن النظرية الحركية لإدراك الخطاب التي تقترح أن هدف تحليل الخطاب هو التعابير الوجهية المرتبطة بالأصوات أكثر من الأصوات نفسها، وُجد أن أثناء إدراك الخطاب تنشط المناطق الحركية الخاصة بالخطاب، وهي تتوافق مع نظام الخلايا المرآتية.
علاوةً على ذلك، وُجد أن معالجة مادة لغوية تُنتج تفعيلًا حركيًا، وأن النشاط العصبي الناتج عن معالجة مادة لغوية مرتبطة بأجزاء الجسم والأفعال ينشط المناطق الجسدية التمثيلية في الدماغ المرتبطة بالقراءة.
الإدراك الاجتماعي والخلايا المرآتية
التشريح العصبي لنظام الخلايا المرآتية الحوفي
النظام المرآتي الثاني هو النظام العاطفي. كما ذكرنا سابقًا، يشارك هذا النظام في تبني سلوكيات متعاطفة، لكنه لا يعمل بالضرورة بمعزل عن النظام الأول، رغم أننا سنعالج هذه النقطة لاحقًا. يقع نظام الخلايا المرآتية أيضًا في مناطق قشرية تتوسط السلوك العاطفي. ملاحظة ألم الآخر تُنتج تفعيلًا في القشرة الحزامية، اللوزة، والجزيرة. الجزيرة مهمة بشكل خاص في دمج التمثيلات الحسية، سواء الداخلية أو الخارجية. تمتلك بنية بلا حُبيبات وتشبه دُخَّلَةً معماريةً خلَوِيَّةً المناطق الحركية.
لذلك تعمل الجزيرة كنقطة اتصال بين النظام الحوفي والتفعيل القشري الجسدي المرتبط بالألم، سواء ألم الذات أو ألم الآخرين، وهو ما يشكل الأساس التطوري للتعاطف. مع ذلك، هذا الأساس ليس وحيدًا. يمكن تأطير نظام التعاطف على النحو التالي:
- أولًا يجب أن يوجد عقدة في هذا النظام، وهي اللوزة، اللازمة لـتفعيل العاطفة لدى الأفراد.
- ثانيًا، مناطق التعبير وتنظيم العاطفة. كما ذكرنا، تتألف منطقة التعبير العاطفي المبنية على مخططات جسدية من هيكلين: أولًا الجزيرة، التي كما قلنا هي مركز تكامل المعلومات الدَّخلية الحسية. من ناحية أخرى توجد القشرة الحزامية، التي تُقسَم على النحو التالي: مقارنةً بالتقسيم الكلاسيكي بين العمليات المعرفية/الظهرية والعاطفية/الأنفية للقشرة الحزامية (Posner et al., 2007)؛ فقد تبيّن مؤخرًا وجود تقسيم فيما يتعلق بالتعبير العاطفي (الداخلي الإحساس) في القشرة الحزامية الأمامية الظهرية، ووظيفة تنظيمية للعواطف في القشرة الحزامية الأمامية الأنفية (Etkin et al., 2010)، وهو ما يتسق مع نظام تحكم أمامي-خلفي مداري (بشكل أساسي جبهوي-حزامي-لوزي).
- ثالثًا، عقدة المعالجة عالية المستوى المكوّنة من نظام الخلايا المرآتية. هذا النظام يتألف من الجزيرة والقشرة الجبهية الوسطى الأمامية. في الواقع يتداخل نظام الخلايا المرآتية في الجزيرة مع نظام التعبير العاطفي الداخلي. تتنوع تداخلات هذا النظام مع العاطفة اعتمادًا على تعقيد الفعل العاطفي.
كيف يعمل نظام الخلايا المرآتية في الإدراك الاجتماعي؟
يعمل نظام الخلايا المرآتية بطريقتين فيما يتعلق بالإدراك الاجتماعي:
- أولًا، هو ضروري لـالتنبؤ ونسبة الأفكار (نظرية العقل).
- ثانيًا، يطلق آليات التعرف والتعبير العاطفي. تم شرح النظام الأول الخاص بالتنبؤ: الأفعال المرصودة تُحَسَب في نظام الخلايا المرآتية الجبهوي-الجداري، مع العواقب.
يعمل هذا النظام كنموذج تنبؤي متطور: من سلوكيات وعمليات بسيطة من أسفل إلى أعلى (bottom-up)، يتطور النظام العصبي عبر سنوات إلى نظام تنظيم من أعلى إلى أسفل (top-down)، حيث تُقارن المخططات الحركية المرصودة بالتعلم عبر السنين، وتهدف إلى إنشاء أنماط تنبؤية إحصائية تقلل الخطأ (Kilner et al., 2007). هذه الحسابات هي أيضًا هرمية بالمعنى أن العمليات المنفذة تستجيب لتوزيع هرمي لمحاور الدماغ النظرية. في هذه التسلسلية تتولى الفص الجبهي إجراء الحساب بين السلوك المرصود والحالة العقلية المفترضة، بينما تتكامل القشرة الحركية والجداريّة والثلم الصدغي العلوي لدمج المعلومات البصرية والمخططات الحركية المخزنة.
سنركز فيما يلي على النظام الثاني للتعاطف، الذي يشمل نظام الخلايا المرآتية الحوفي (الجزيرة، القشرة الحزامية والفص الجبهي).
الخلايا المرآتية والتعاطف
دور الخلايا المرآتية في السلوكيات التعاطفية مثل تبني التعابير الوجهية والوضعيات في سلوكيات تقليدية تفاعلية، أساسي إلى جانب التبني العاطفي (النظام الحوفي). كما ذكرنا سابقًا، تحسب الخلايا المرآتية الحركات من حيث عواقب التنفيذ والأهداف. تُشكّل هذه المعرفة أساس الإدراك الاجتماعي، إلى جانب النظام الثاني لدمج العاطفة. التعاطف ليس عملية أحادية الجانب. رغم وجود أدلة على أن ملاحظة العقاب عن الآخر تُنتج تفعيلًا في اللوزة، القشرة الحزامية الأمامية، والجزيرة –بالإضافة إلى المهاد والمخيخ– (Jackson et al., 2005)، فربما تعتمد العملية الكاملة على شبكة واسعة النطاق، مع مناطق معالجة عالية تُؤثر أو تستثير استجابات عاطفية.
في الواقع، قد يكون هذا دور الخلايا المرآتية في التعاطف. التعاطف مدعوم بشبكة عصبية واسعة النطاق تتألف من نظام الخلايا المرآتية، النظام الحوفي، والجزيرة، التي تعمل كنقطة ربط بين النظامين. داخل هذه الشبكة، توفر الخلايا المرآتية محاكاة للتعابير والإيماءات الوجهية المرصودة لدى الآخرين إلى مناطق المعالجة منخفضة المستوى، عبر الجزيرة، مما يؤدي إلى نشاط في تلك المناطق. وأخيرًا، يُحدث ذلك حالةً عاطفية في المراقب للسلوك المرصود. بهذه الطريقة تُقدّم للمُشاهِد نظامًا بديلًا للعواطف قائمًا على المحاكاة، يُسهِم جزئيًا في الإدراك الاجتماعي.
تُدعى هذه النظرية «نظرية المحاكاة» (Gallese & Goldman, 1998؛ مقتبسة في Frith & Frith, 2006)، وتقترح أننا بهذه الطريقة نستطيع فهم العواطف التي نرصدها من خلال الحالات الداخلية التي تولدها فينا. لذلك، أكثر طرق التعاطف شيوعًا هي تبني وضعية الآخر حرفيًا، لمحاكاتها داخليًا. ومرة أخرى، عندما نحاول تبني وضعية الشخص الذي يعبر عن مشاعره، نقوم بذلك وجهيًا، مما ينشط النظام الحوفي.
باختصار، تمتلك الخلايا المرآتية أساسًا حسيًا-حركيًا للتعاطف. عند الحديث عن هذا النظام من الخلايا المرآتية وعلاقته بالتعاطف، من الضروري إجراء تمييز: فهم العواطف ومحاكاتها ليس الخطوة الوحيدة للإدراك الاجتماعي، إذ يجب أن نأخذ في الاعتبار الشخصية المستقرة للشخص من أجل إجراء تنبؤات.
في هذا الجانب، من المثير للاهتمام إجراء، مرة أخرى، تمييزًا: عصبيًا، هل التفكير في السلوك والعاطفة المحتملين لشخص يشبهنا هو ذاته لشخص مختلف؟ ليس كذلك. التفكير في شخص مشابه لنا عادةً ينشط مناطق القشرة الجبهية الوسطى البطنية، خاصة AB 18، 9، 57 و10، بينما التفكير في ردود الفعل والسمات المحتملة للآخرين ينشط مناطق القشرة الجبهية الظهرية، AB 9، 45 و42 (Frith & Frith, 2006).
في الواقع، توجد محور وظيفي في الدماغ من الوسط إلى الجوانب، حيث ترتبط المناطق الأكثر مركزية بتمثيل الذات وعواطفها الخاصة، بينما تشارك المناطق الجانبية في تمثيل العالم الخارجي والآخرين. تستند هذه الفرضية حول محور وسط-جانبي إلى أن المناطق الوسطية غالبًا ما تظهر ارتباطًا أكبر مع المراكز الحوفية ومعلومات الحس الداخلي الخاص، وبالتالي تتأثر أكثر بالبيانات الحسية، بينما المناطق الجانبية تكون أكثر انعكاسية ومعتمدة على التمثيلات عن العالم الخارجي. يذكر Amodio & Frith (2006) عقدة مركزية في معالجة الإدراك الاجتماعي: القشرة الجبهية الوسطى (AB 10).
نظام الخلايا المرآتية والتأهيل الحركي
على الرغم من شرح وظيفة نظام الخلايا المرآتية في التعلم الحركي، من المثير الإشارة إلى مشاركته في تشكيل مخزن ذاكرة حركي. أقوى الأدلة تأتي من دراسات Stefan et al. (2007)، حيث يُظهر المؤلفون كيف أن تعلم تسلسل حركي عبر الملاحظة يعزز تكوين ذاكريات حركية مقارنةً بالتعلم بمفرده. وُجد أن التعلم بالملاحظة يمكن أن يوسّط عمليات اللدونة العصبية طويلة الأمد لدى الفرد، وأن هذا التأثير يتوسطه نظام الخلايا المرآتية في القشرة الحركية.
في دراسة أجراها Ertelt et al. (2008) خضع مجموعتان من المرضى المصابين بسكتة في الشريان الدماغي المتوسط وذراع شلل متنحي لعلاجات مختلفة: واحدة بإشارات سمعية بصرية، وأخرى بدون إشارات. المجموعة التي اتبعت التدريب بعينات بصرية سمعية للتمارين أظهرت تحسنًا أكبر في الطرف المشلول مقارنةً بمجموعة التحكم. بالإضافة إلى ذلك، تم اقتراح العلاج بالمِرْآة كبديل يؤدي إلى تغييرات في اللدونة. في هذا العلاج، يتدرَّب المريض بطرفه السليم أمام مرآة تُظهره في انعكاس شبه سِهمي، مما يُحدث وهمًا بصريًا للطرف المشلول. تُظهر نتائج العلاج توليد لدونة قشرية.
الخلايا المرآتية والعلاج في اضطرابات طيف التوحد (التوحد وأسبرجر)
النمو والخلل الوظيفي
هناك أدلة غير مباشرة على نشاط الخلايا المرآتية منذ السنة الأولى من العمر لتنبؤ أهداف الأشخاص المرصودين (Falck-Ytter etal., 2006; مقتبس في Iacoboni & Dapretto, 2006). لدى الأطفال دون 11 عامًا، هذه الأدلة، وإن كانت أقل متانة منها لدى البالغين (وهو أمر منطقي إذا اعتبرنا أن النظام ليس مكتمل النضج من منظور الاتصالية)، تظهر مؤشرات تفعيل للخلايا المرآتية عبر معايير متعددة (قمع تردد موجة mu، تخطيط الدماغ الكهربائي EEG، مطيافية الأشعة تحت الحمراء، التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي) لأنشطة التقليد والكفاءة الاجتماعية والتعاطف. لذلك، ومع أنه إلى اليوم لا يُعرف بدقة مدى تورط نظام الخلايا المرآتية في السلوك الاجتماعي، فمن الواضح أنه يلعب دورًا محوريًا ما.
ربما أحد المفاتيح التي تسمح بتحديد أهميته هو خلله لدى الأطفال المصابين بالتوحد واضطرابات الاتصال الأخرى. في التوحد، طُرح وجود عجز في المحاكاة العصبية في نمذجة السلوكيات المرصودة، مما يمنع «الفهم التجريبي» الصحيح للآخرين. تم التحقق من هذا العجز عصبيًا في دائرة الخلايا المرآتية، حيث توجد شذوذات بنيوية لدى الأفراد ذوي اضطرابات طيف التوحد.
على سبيل المثال، يمنع هذا الاضطراب تحديدًا صحيحًا للعواطف في التعابير الوجهية لأنه لا يحدث تفعيل مناسب للدائرة المركزية. ومع ذلك، فإن الأفراد المصابين بالتوحد قادرون على تحديد الفعل غير العاطفي –على الرغم من أنهم لا يعرفون الغرض الذي يُؤدَّى من أجله–، مما يشير إلى اضطراب في دائرة الخلايا المرآتية الحوفية أكثر حدة من آلية التقليد. هذا العجز يرتبط بشدة الاضطراب.
البيانات المقدمة حول أسبرجر تؤكد وجود عجز مشابه وإن كان أقل حدة (قائمًا على صعوبة وتأخر زمني في اكتساب السلوكيات) يشمل التقليد، مما يوحي أن التقليد قد يلعب دورًا مهمًا في العلاج مع هؤلاء الأفراد. قد تنطوي العلاج مع الأشخاص الذين يعانون اضطرابات طيف التوحد على استهداف نظام الخلايا المرآتية. هناك أدلة تجريبية أن الاضطراب يتضمن، على الأقل جزئيًا، عجزًا في التقليد وفي إنتاج اللغة، وأن نظام الخلايا المرآتية متورط في هذا الاضطراب (Wan et al., 2010).
أُظهر أن العلاج بالموسيقى يُفضي إلى تحسن الأعراض. وبما أن النظام الحسي-حركي مشترك في معالجة اللغة، وهناك أيضًا تعديل للنشاط الحركي أثناء معالجة اللغة، فيبدو منطقيًا التفكير أن وسيلة لتنشيط نظام الخلايا المرآتية قد تُحسّن كلا العرضين. والموسيقى تولّد نشاطًا في النظام، مما يدعم تعديله (بشكل إيجابي) ويوفر لدونة عصبية، إذ إن الموسيقى أيضًا فعل تعبيري حركي، وتُنشط، من بين مناطق أخرى، منطقة بروكا (AB 44). فعلاً، هذا النوع من العلاج المدمج مع الغناء يظهر تأثيرات مفيدة في مرضى أفازيا بروكا، كثير منهم قادرون على نطق الكلمات المدمجة بنغمة مختلفة عن النبرة الطبيعية.
مقارنةً بفعل الكلام، يُنتج الغناء تفعيلًا ثنائي الجانب لشبكة جبهية-صدغية، ويشارك جزء من هذه الشبكة بالخلايا مع آلية الخلايا المرآتية. هذا التداخل يُحسّن مخططات التنسيق السمعي-الحركي، وهو عجز في التفعيل يُرى في الأشخاص الذين يعانون هذا النوع من اضطرابات الاتصال.
فيما يتعلق بالتقليد، يختلف مدى التطبيق والفعالية بنفس طريقة البيانات التجريبية المعروضة سابقًا. يبدو أن الأطفال المصابين بأسبرجر يظهرون تطورًا جيدًا، خاصة إذا أُجري العلاج مبدئيًا مع أشخاص مقربين من المتأثر، وأكثر عند استخدام مقاطع فيديو للشخص نفسه. تم التحقق من هذه البيانات في قمع موجات mu في القشرة الحسية-الحركية، جزء من نظام الخلايا المرآتية.
المراجع
- Cattaneo, L., & Rizzolatti, G. (2009). The mirror neuron system. Archives of Neurology, 66(5), 557-560.
- Ertelt, D., Small, S., Solodkin, A., Dettmers, C., McNamara, A., Binkofski, F., & Buccino, G. (2007). Action observation has a positive impact on rehabilitation of motor deficits after stroke. NeuroImage, 36 Suppl 2, T164-173.
- Frith, C. D., & Frith, U. (2006). The neural basis of mentalizing. Neuron, 50(4), 531-534.
- Grafton, S. T., & Hamilton, A. F. D. C. (2007). Evidence for a distributed hierarchy of action representation in the brain. Human Movement Science, 26(4), 590-616.
- Hickok, G. (2010). The Role of Mirror Neurons in Speech and Language Processing. Brain and language, 112(1), 1.
- Iacoboni, M. (2009). Imitation, empathy, and mirror neurons. Annual Review of Psychology, 60, 653-670.
- Iacoboni, M., & Dapretto, M. (2006). The mirror neuron system and the consequences of its dysfunction. Nature Reviews. Neuroscience, 7(12), 942-951.
- Jackson, P. L., Meltzoff, A. N., & Decety, J. (2005). How do we perceive the pain of others? A window into the neural processes involved in empathy. NeuroImage, 24(3), 771-779.
- Kemmerer, D., & Castillo, J. G. (2010). THE TWO-LEVEL THEORY OF VERB MEANING: AN APPROACH TO INTEGRATING THE SEMANTICS OF ACTION WITH THE MIRROR NEURON SYSTEM. Brain and language, 112(1), 54-76.
- Kilner, J. M., Friston, K. J., & Frith, C. D. (2007). Predictive coding: an account of the mirror neuron system. Cognitive Processing, 8(3), 159-166.
- Le Bel, R. M., Pineda, J. A., & Sharma, A. (2009). Motor-auditory-visual integration: The role of the human mirror neuron system in communication and communication disorders. Journal of Communication Disorders, 42(4), 299-304.
- Oberman, L. M., & Ramachandran, V. S. (2007). The simulating social mind: the role of the mirror neuron system and simulation in the social and communicative deficits of autism spectrum disorders. Psychological Bulletin, 133(2), 310-327.
- Oztop, E., Kawato, M., & Arbib, M. (2006). Mirror neurons and imitation: a computationally guided review. Neural Networks: The Official Journal of the International Neural Network Society, 19(3), 254-271.
- Rizzolatti, G., Fabbri-Destro, M., & Cattaneo, L. (2009). Mirror neurons and their clinical relevance. Nature Clinical Practice. Neurology, 5(1), 24-34.
- Vogt, S., & Thomaschke, R. (2007). From visuo-motor interactions to imitation learning: behavioural and brain imaging studies. Journal of Sports Sciences, 25(5), 497-517.
- Wan, C. Y., Demaine, K., Zipse, L., Norton, A., & Schlaug, G. (2010). From music making to speaking: engaging the mirror neuron system in autism. Brain Research Bulletin, 82(3- 4), 161-168.
“تمت ترجمة هذا المقال. رابط المقال الأصلي باللغة الإسبانية:”
Sistema de Neuronas Espejo: función, disfunción y propuestas de rehabilitación

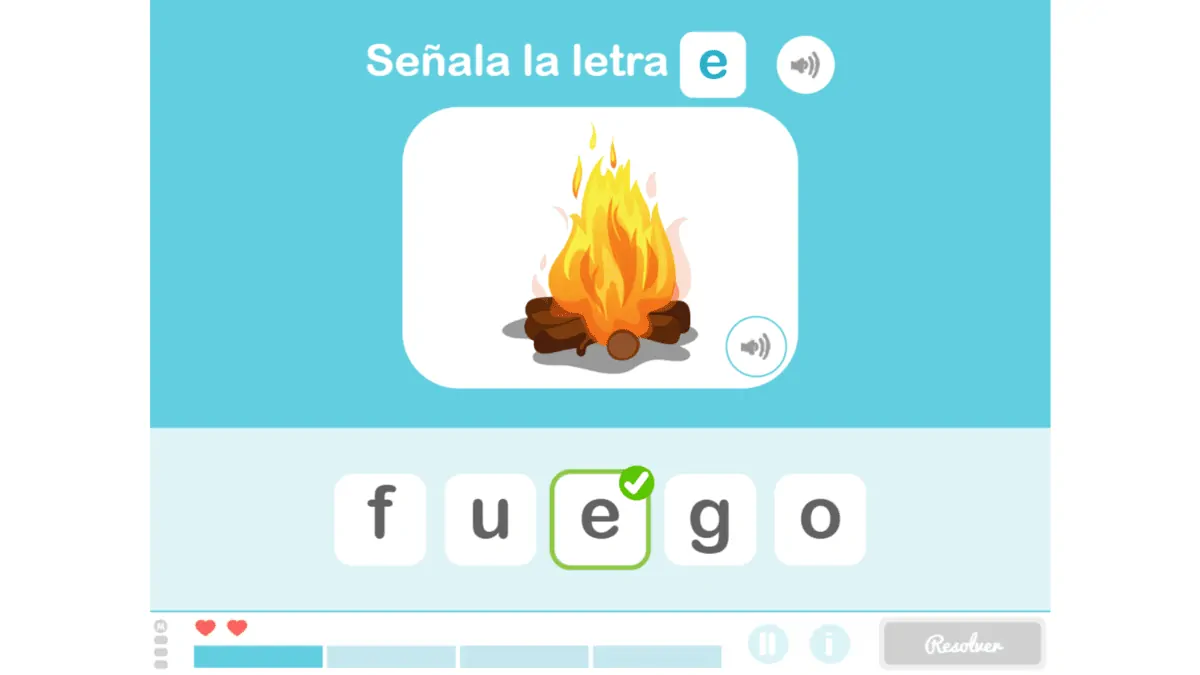

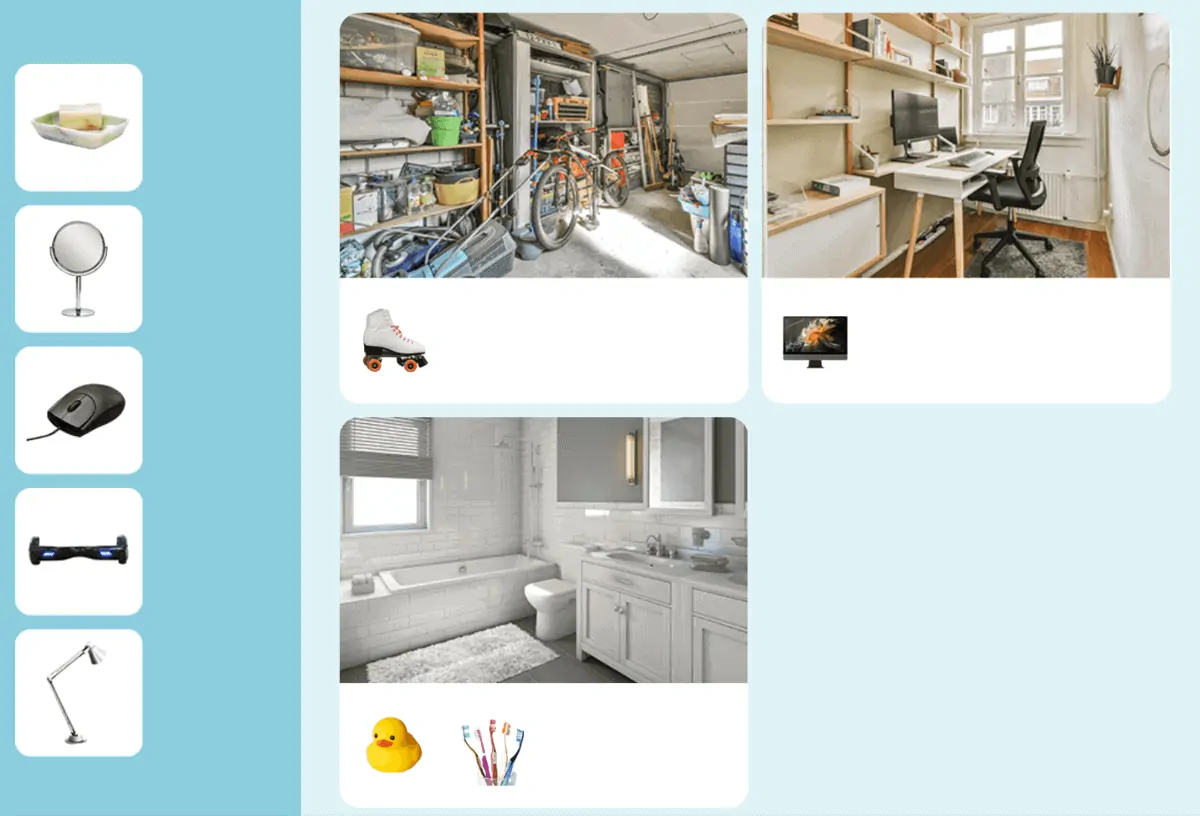



 التدخل النفسي-التعليمي لدى الأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD)
التدخل النفسي-التعليمي لدى الأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD)
اترك تعليقاً