تشرح جمعية مرسية لعلوم الأعصاب العلاقة بين التوحد والدماغ والأسباب العصبية الحيوية التي تؤدي إلى الإصابة بالتوحد.
مقدمة عن التوحد والدماغ
التوحد هو اضطراب عصبي حيوي في التطور يظهر خلال الثلاث أو الأربع سنوات الأولى من الحياة. بالإضافة إلى ذلك، هو اضطراب يستمر على مدار دورة الحياة. رغم أن كل متلازمة توحد تختلف في أعراضها، يوجد عاملان مشتركان لهذا الاضطراب:
- يعاني الطفل أو الطفلة من عجز مستمر في التفاعل والتواصل الاجتماعي
- يمتلك أنماطًا مقيدة ومتكررة من السلوك أو المصالح أو الأنشطة (Volden, 2017).
الأسباب العصبية الحيوية
يترافق التوحد أساسًا مع عجز سلوكي؛ ومع ذلك، أظهرت العديد من البحوث أن المشكلة تبدأ في التطور العصبي للجنين. فيما يلي، ستُوصف أحدث خطوط البحث حول الأسباب العصبية الحيوية التي تؤدي إلى الإصابة بهذا الاضطراب.
التوحد وحجم الدماغ
أولًا، وجد بعض الباحثين علاقة بين درجة النمو المفرط للدماغ وشدة أعراض التوحد. بالفعل، أظهرت دراسات التصوير بالرنين المغناطيسي البنيوي أن النمو المفرط لدماغ الطفل/الطفلة المصاب بالتوحد يبدأ خلال السنة الأولى من الحياة، أو حتى قبل ذلك (Amaral et al., 2017; Kessler, Seymour و Rippon, 2016). ومع أن سبب هذا النمو المتسارع لا يزال غير معروف حتى الآن، فإن هذه البيانات تمثل تقدمًا كبيرًا في التشخيص والعلاج المبكر للتوحد.
التوحد والتنظيم غير الطبيعي لقشرة الدماغ
ثانيًا، قشرة الدماغ تميل إلى التنظيم في مناطق متميزة منذ الأشهر الأولى من حمل الجنين. ومع ذلك، لوحظ أن هذا التمايز لا يحدث بنفس الطريقة لدى الأطفال المصابين بالتوحد. في إحدى الدراسات، قورنت بواسطة تقنية تصوير مقطعي تنظيمية أدمغة أطفال شخصت لديهم حالة التوحد وتمت مقارنتها بأدمغة آخرين لم يُشخصوا بالتوحد. في تلك الدراسة، كان كلا المجموعتين في أعمار بين سنتين و15 سنة. ونتيجة لذلك، تبين أن أدمغة الأطفال المصابين بالتوحد كانت تحتوي على مناطق غير منظمة، مع وجود خلايا في مواضع غير صحيحة في القشرة الأمامية المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالتواصل والتفاعل الاجتماعي (Sanz-Cortes, Egana-Ugrinovic, Zupan, Figueras و Gratacos, 2014). دراسات لاحقة دعمت هذا الاكتشاف واقترحت أن أحد الأسباب المحتملة هو سوء النمو العصبي خلال الثلثين الثاني والثالث من الحمل.
التوحد وقلة تنشيط اللوزة
بالتأكيد، اللوزة هي البنية الدماغية المسؤولة عن معالجة المشاعر. لدرجة أن وظيفتها العاطفية هامة جدًا لدرجة أن إصابة اللوزة تجعل الشخص عاجزًا عن التعرف على مشاعر الآخرين أو التعبير عنها أو حتى تسميتها. بعض الدراسات الرائدة التي استخدمت تقنية التصوير الوظيفي بالرنين المغناطيسي أظهرت أن مستوى نشاط اللوزة لدى الأطفال المشخصين بالتوحد كان أقل عندما أجابوا على مهمة التعرف على المشاعر، مقارنة بمستوى تنشيط أطفال في نفس العمر لكن بدون تشخيص (Barnea-Goraly et al., 2014). كما وجد مؤلفون آخرون فروقًا شكلية وحساسية بين وظائف لوزة طفل مصاب بالتوحد ولوزة طفل دون التشخيص (Kiefer et al., 2017).
التوحد وتباطؤ التطور الوظيفي للدماغ
على الرغم من عدم وجود بيانات حاسمة حتى الآن، كشفت بعض الأبحاث أن المناطق الدماغية المشاركة في التواصل والتفاعل الاجتماعي تنمو وتصبح وظيفية بوتيرة أبطأ لدى الأطفال المصابين بالتوحد مقارنةً بالأطفال غير المصابين بالاضطراب (Ameis و Catani, 2015; Washington et al., 2014). ولهذا السبب يُفسَّر العجز لدى هؤلاء الأطفال في إقامة روابط عاطفية والتواصل مع البيئة.
كما يتضح في هذه المقالة، هناك العديد من النظريات التي تحاول تفسير التوحد. بالتأكيد، يعود هذا الكم من الفرضيات إلى تنوع الأعراض التي يظهرها الاضطراب نفسه ولتعقيد ما يحويه التوحد. ومع ذلك، تبدو خطوط البحث المستقبلية المشجعة أنها تدعم الاقتراحين الأولين، مما سيمكن المتخصصين مثل علماء النفس والأعصاب النفسية، وغيرهم، من فهم التوحد بشكل أفضل وسبل الوقاية والتدخل عبر دورة الحياة.
المراجع
- Amaral, D. G., Li, D., Libero, L., Solomon, M., Van de Water, J., Mastergeorge, A., … و Wu Nordahl, C. (2017). In pursuit of neurophenotypes: The consequences of having autism and a big brain. Autism Research, 10(5), 711-722.
- Ameis, S. H. و Catani, M. (2015). Altered white matter connectivity as a neural substrate for social impairment in Autism Spectrum Disorder. Cortex, 62, 158-181.
- Barnea-Goraly, N., Frazier, T. W., Piacenza, L., Minshew, N. J., Keshavan, M. S., Reiss, A. L. و Hardan, A. Y. (2014). A preliminary longitudinal volumetric MRI study of amygdala and hippocampal volumes in autism. Progress in Neuro Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 48, 124-128.
- Kessler, K., Seymour, R. A. و Rippon, G. (2016). Brain oscillations and connectivity in autism spectrum disorders (ASD): new approaches to methodology, measurement and modelling. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 71, 601-620.
- Kiefer, C., Kryza-Lacombe, M., Cole, K., Lord, C., Monk, C. و Wiggins, J. L. (2017). 126-Irritability and Amygdala-Ventral Prefrontal Cortex Connectivity in Children with High Functioning Autism Spectrum Disorder. Biological Psychiatry, 81(10), 53-58.
- Sanz-Cortes, M., Egana-Ugrinovic, G., Zupan, R., Figueras, F. و Gratacos, E. (2014). Brainstem and cerebellar differences and their association with neurobehavior in term small-for-gestational-age fetuses assessed by fetal MRI. American journal of obstetrics and gynecology, 210(5), 452-459.
- Volden, J. (2017). Autism Spectrum Disorder. California: Springer International Publishing.
- Washington, S. D., Gordon, E. M., Brar, J., Warburton, S., Sawyer, A. T., Wolfe, A., … و Gaillard, W. D. (2014). Dysmaturation of the default mode network in autism. Human brain mapping, 35(4), 1284-1296.
إذا كنت مهتمًا بهذه المقالة حول التوحد والدماغ، فمن المؤكد أنك مهتم أيضًا بـ:
“تمت ترجمة هذا المقال. رابط المقال الأصلي باللغة الإسبانية:”
Autismo y cerebro: causas neurobiológicas del autismo

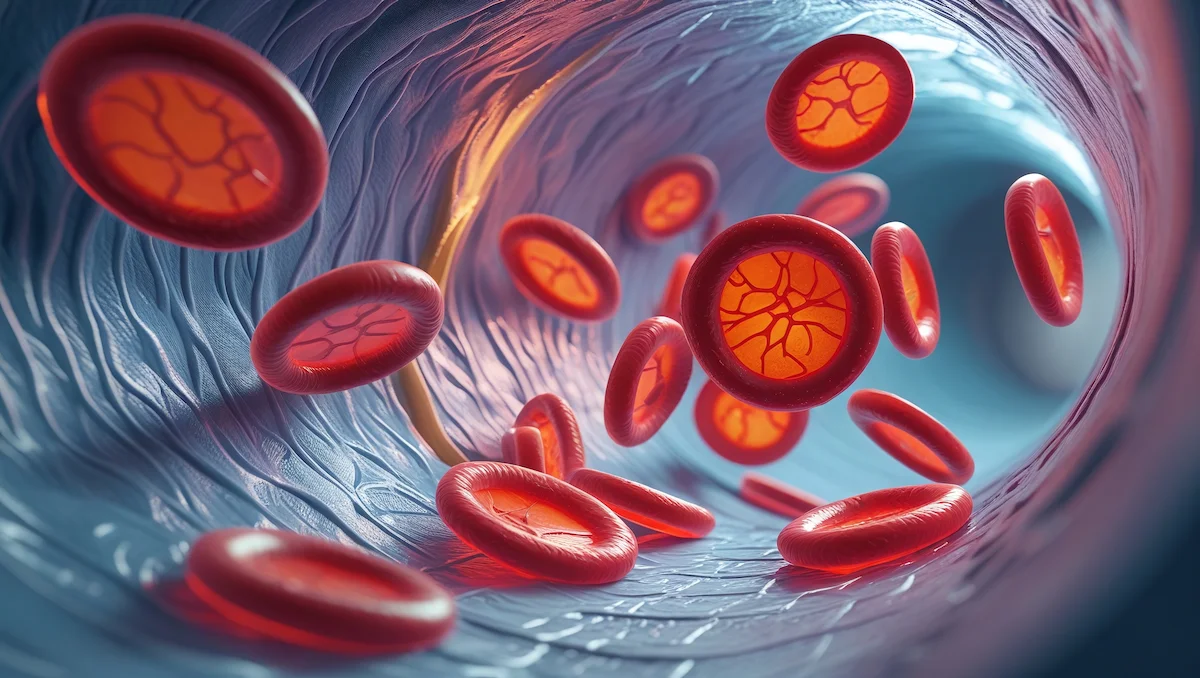
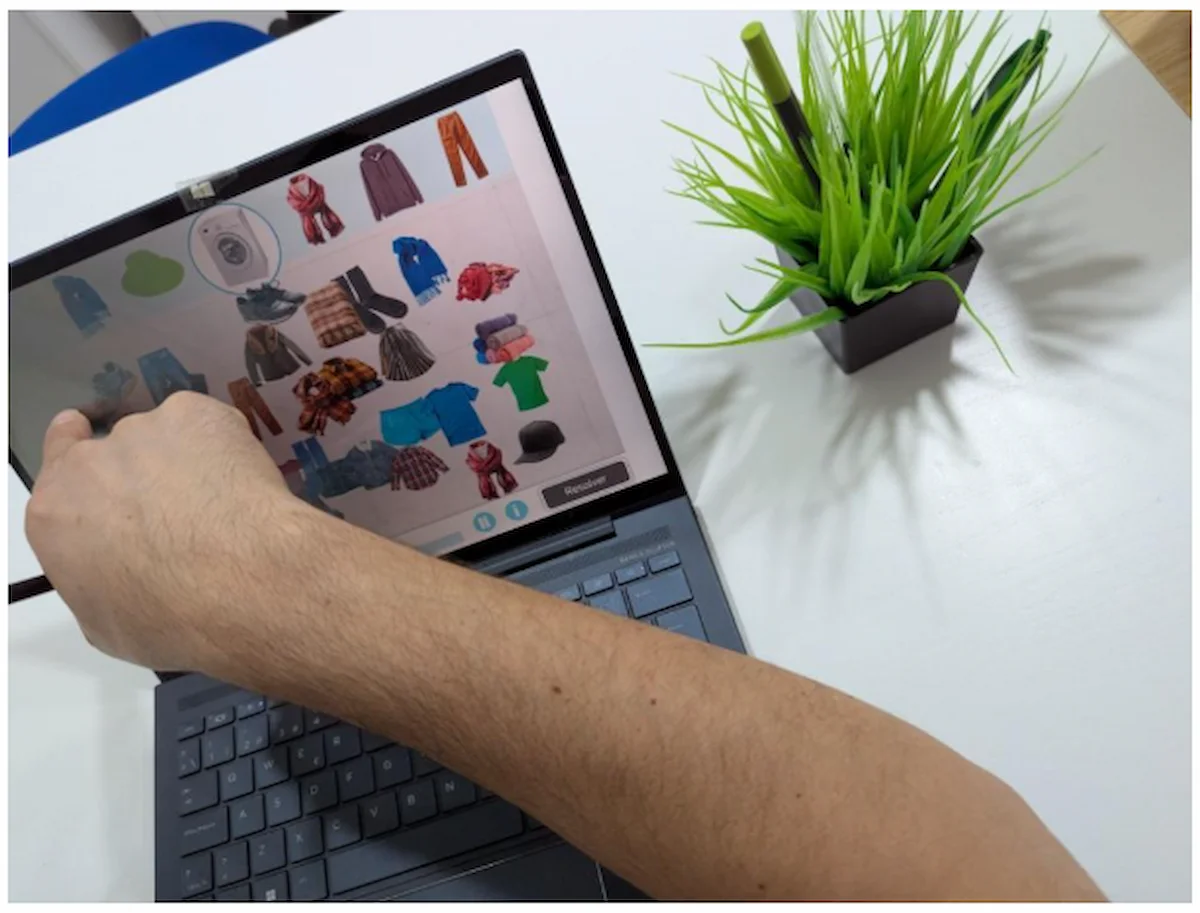
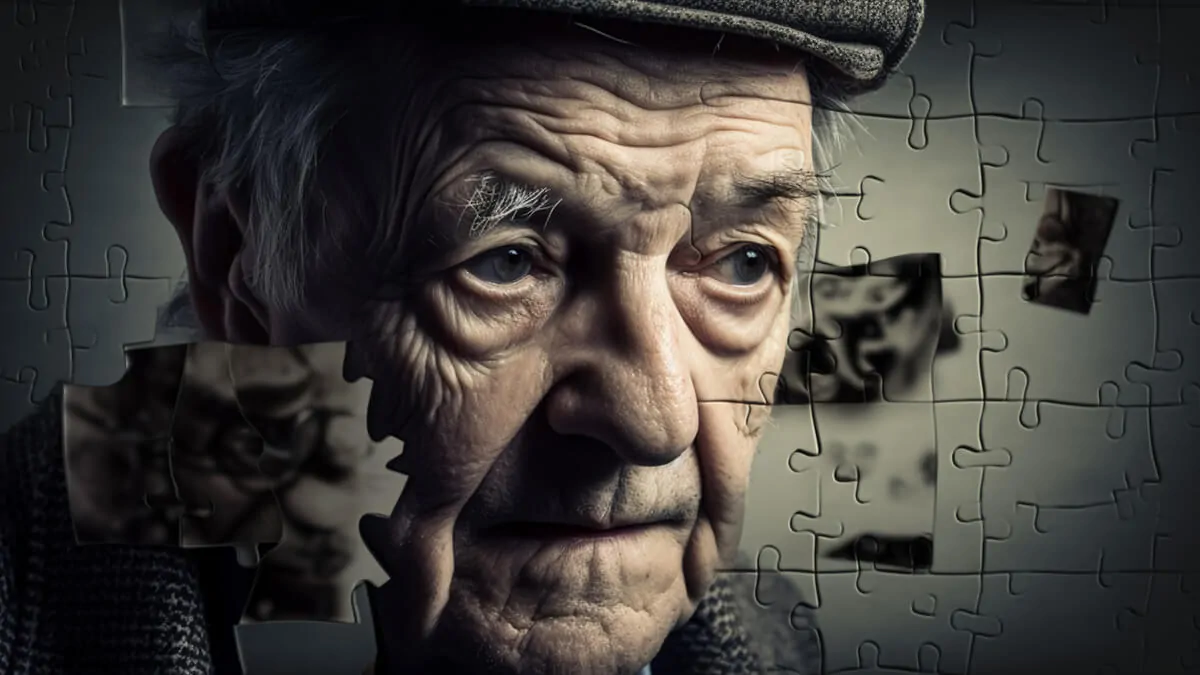


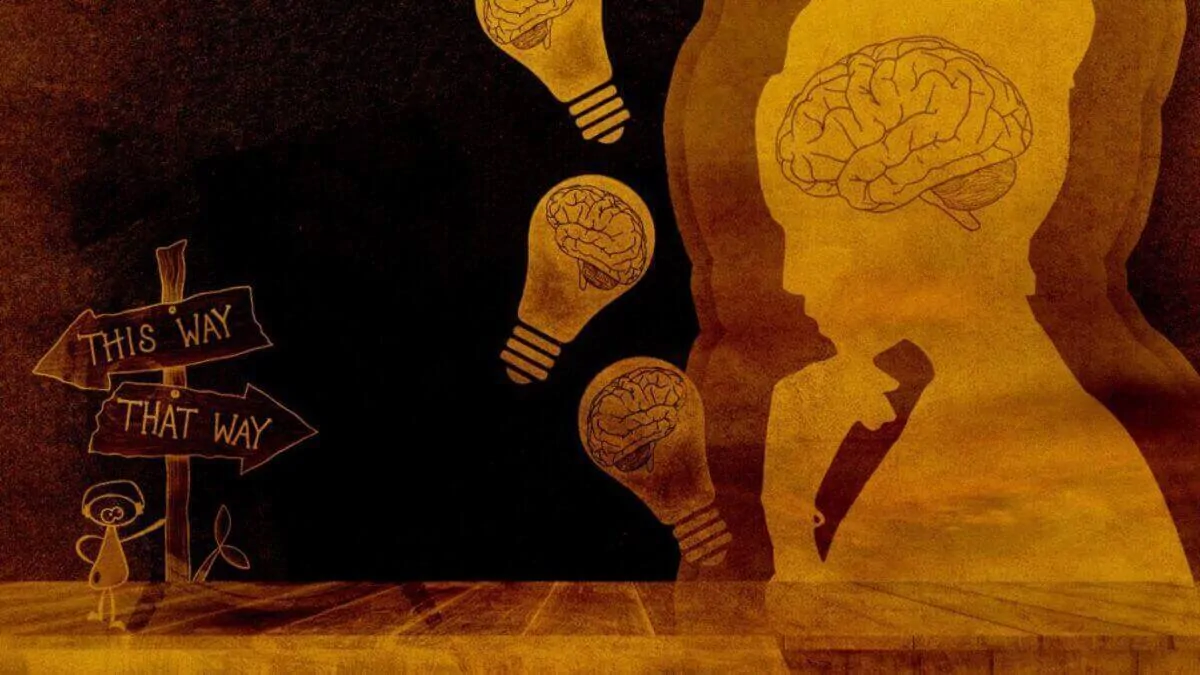
 متلازمة مواء القطة وإعادة التأهيل العصبي النفسي
متلازمة مواء القطة وإعادة التأهيل العصبي النفسي
اترك تعليقاً